لا تخلو منطقة من مناطق المغرب من حكايات الكنوز، حكايات تختلط فيها الوقائع التاريخية وتفاسير النصوص الدينية مع الخرافات والأساطير الشعبة. ونجد في زماننا هذا من لا زال يجري وراء حلمه في العثور على نصيبه من هذه الثروات المدفونة تحت الأرض.
وترتبط الأمكنة التي يدعى أن كنوزا استخرجت منها، أو لا تزال، بالأضرحة ارتباطا وثيقا، ففي بلادي مثلا (نواحي مدينة وزان)، سيدي مرزوق وللا سلطانة… من بين الأماكن التي نسجت حولها الحكايات، وقصدها الباحثون عن الكنوز من كل حدب وصوب، وحفروا أراضيها ليلا ونهارا، حتى حولوها ثقوبا.
من الحكايات التي سمعناها تتردد هنا وهناك، لكن دائما قالوا، والقائل مجهول، أو تنتهي العنعنة إلى، أو تمر عبر، حاك غير موثوق. أن:
– رجلا طار به “رجال البلاد” ورموه في أحد الأودية، بينما كان يحفر الأرض باحثا عن كنز.
– وآخر تظهر له الأفاعي والمخلوقات العجيبة، ولكنه لا يبالي بها…
– وشابا ضرب رجله بفأس.
– وآخر أصبح أخرسا، ثم صار يكلم نفسه تكليما.
– وجرافة أبت أن تسير في اتجاه “السيد”، وانقلبت بسائقها.
– وكثيرين وجدوا الكنز، ولكنه تحول إلى رماد بسبب أخطاء ارتكبوها أثناء سير العمليات.
أما المفلحون فهم الذين ظهرت عليهم آثار النعمة، لكنهم ينكرون.
…..
أما “البرية” أو “السيدة” كما كنا نطلق عليها، وهي عبارة عن شجرة زيتون بري توجد قرب السانية حيث مورد البهائم، فكنا نكاد نقدسها، لما كنا نسمع عنها ورغبة منا في السلم، حيث كانت تلزمنا رحلتا الذهاب إلى المدرسة البعيدة في ظلمة الفجر والعودة منها في ظلمة ما بعد المغرب إلى المرور بجانبها.
توجد البرية بجانب الواد، وكان سكان القرية يتحاشون، تكسير أي غصن منها، ويوصون أبناءهم بذلك، حتى لا تصيبهم لعنتها (تفلسهم السيدة)، لذلك نمت أغصانها وتفرعت جدوعها ومالت في كل الاتجاهات، وحفرت سيول الوادي حفرا من تحتها، فصارت سراديب تقشعر من رهبتها أبداننا الصغيرة كلما مررنا بجانبها.
بين السانية والبرية يوجد منبسط جعلناه نحن الصغار ملعبا لكرة القدم، واقع فرض علينا التعامل مع سراديب البرية في كل مرة توجه فيها قدفاتنا الطائشة الكرة في اتجاهها وبمرور السنين بدأت البرية تفقد هيبتها، فصرنا نتسلق أغصانها، بل نسترق القطع النقدية التي يضعها الكبار في تجويف أحد جدوعها.
على عكس الأضرحة المتواجدة بالمنطقة، البرية كانت تخلو من أية أحجار متراصة كما القبور لتبرر لقب السيدة. وهذا ما رحج لدى الأجيال فكرة أن أحدهم جعلها شاهدا لكنز دفنه عند جدعها في زمن غابر، وروج لفكرة أنها “مسكونة”، أو صارت كذلك بعد أربعين سنة كما يحكي العارفون بأساطير الكنوز.
يزكي لدى أهل القرية فكرة أن السيدة تحتضن كنزا مدفونا، ما يتواتروه عن بعض الغرباء الذين يزورون المنطقة، فيحكي أحدهم ما أخبره به فقيه سوسي (من أهل الاختصاص) أن كنزا عظيما هناك، محاطا بعفاريت شداد مكبلين بسلاسل تحرسه. ويحكي آخر أنه شاهد جماعة تلبس الأبيض تطوف بالبرية بعد منتصف الليل…
دارت الأيام ومرت السنون، واختلف الناس في آرائهم حول البرية، فأصبح هناك من يكذب تلك المعتقدات جملة وتفصيلا، وهناك من يعتقد بوجود الكنز لكن جذور البرية تشابكت حوله، فيلزم اقتلاع الشجرة العظيمة من حذورها لاستخراجه، لكن أغلبيتهم لا تزال تحافظ على اعتقادها ولو بدرجات متفاوتة.
في ظل التجادبات والنقاشات التي تدور بين أصحاب هذه التواجهات، وفي أحد الأيام، كان الوقت صيفا والجو حارا، حيث اعتاد الكبار أخذ قيلولة منتصف النهار، كنا نحن الشباب نجلس تحت البرية، وقادنا الحديث إلى المراهنة على من يقوم بحفر المكان الذي يعتقد أن “اللأمانة” توجد تحت ترابه. لم ننتظر طويلا، تولينا المهمة نحن الثلاثة: أنا الرافض لفكرة “البرية مسكونة”، والعربي، المولع بالصيد الذي كثيرا ما يقوده ولعه إلى قضاء ليال خارح البيت. وعامل قوي البنية خفيف الدم، لم نكن نعرف له اسما غير “حنيني” الذي سرعان ما انضم إلينا بفأس ومجرفة، كان يستخدمهما في إعداد الطوب (المقدار).
بدأنا الحفر في جو تباينت فيه ردود أفعال الآخرين، بين منسل من المكان، ومراقب من بعيد، وباق متفرج أو محذر أو ناصح أو مازح. بينما نحن الثلاثة انهمكنا في العمل على إيقاعات مستملحات “حنيني” الذي يضحك من الرجل الغني الذي سيصبحه حينا، ويتوعد “عيشة قنديشة” بالهلاك إن هي تبدت له أحيانا.
ما هي إلا بضع دقائق حتى كنا قد أزحنا ما يمكن إزاحته من تراب، فبدأت تنكشف جذور البرية المتشابكة لدرجة يصعب تجاوزها. وفي الوقت الذي كنا نتبادل الآراء حول ما ينبغي فعله لمواصلة الحفر دون الإضرار بالشجرة، كان الخبر قد وصل على عجل إلى منزل صاحب الفأس الذي كان “حنيني” يعمل لديه. على عجل كذلك جاء اللأمر من “مولاة الدار” زوجة رب العمل، وهي امرأة كأغلب نساء القرية اللواتي يعتبرن الأكثر اعتقادا بالسيدة، فكثيرا ما جاورنها في تحضير الكسكس الجماعي في المواسم والصدقات أو طلب الغيت عند انحباس المطر، كم أتذكر بحنين تلك العبارات التي كن يرددنها في جو حميمي تذوب فيه كل الخلافات:
“غيتك غيتك يالله &&& وا الشتا من عند الله”
“وا الفويلة العطشانة &&& وا رويها يا مولانا”
من بعيد أطل جمال مهرولا ومخاطبا أخاه عبد الكريم: “واااا عبد الكريــــــــم وا قالت لك أمي أرا الفــــــــاس! وا أرا الفــــــــاس! أرا الفــــــــاس! دابا أرا الفاس!، وا لي بغى يحفر يمشي يجيب الفاس من الدار ديالهم!” وعلى هذا الإيقاع انتهى الحفر… فلا الكنز وجدنا ولا “حنيني” حسم معركته مع عيشة قنديشة…
حوالي عشرين سنة مرت على هذه الأحداث، وآثار الحفر لا تزال شاهدة على فعلتنا التي إن كان لها من أثر، ولو قليل، فعلى قلة من أطفال الأمس، شباب اليوم. أما الكبار و منهم نحن شباب آنذاك فقد انشغل كل واحد منا بمسار حياته، ولم يعد للسيدة البرية حيز في اهتماماته، باستثناء صنف غريب من الناس…
هم فعلا صنف غريب، فقد صنعوا مني وممن كان معي حكاية من الحكايات التي تشحن بها عقول الصغار، ليزرعوا فيهم الرعب كما ورثوه من أمثالهم. لقد التقطوا أحداثا متفرقة ومختلفة في الزمان والمكان والظروف، فقالوا: “حفر فلان البرية، فبات الليل يهلوس، ثم مرض بالحمى أسبوعا كاملا”.
7يناير 2018






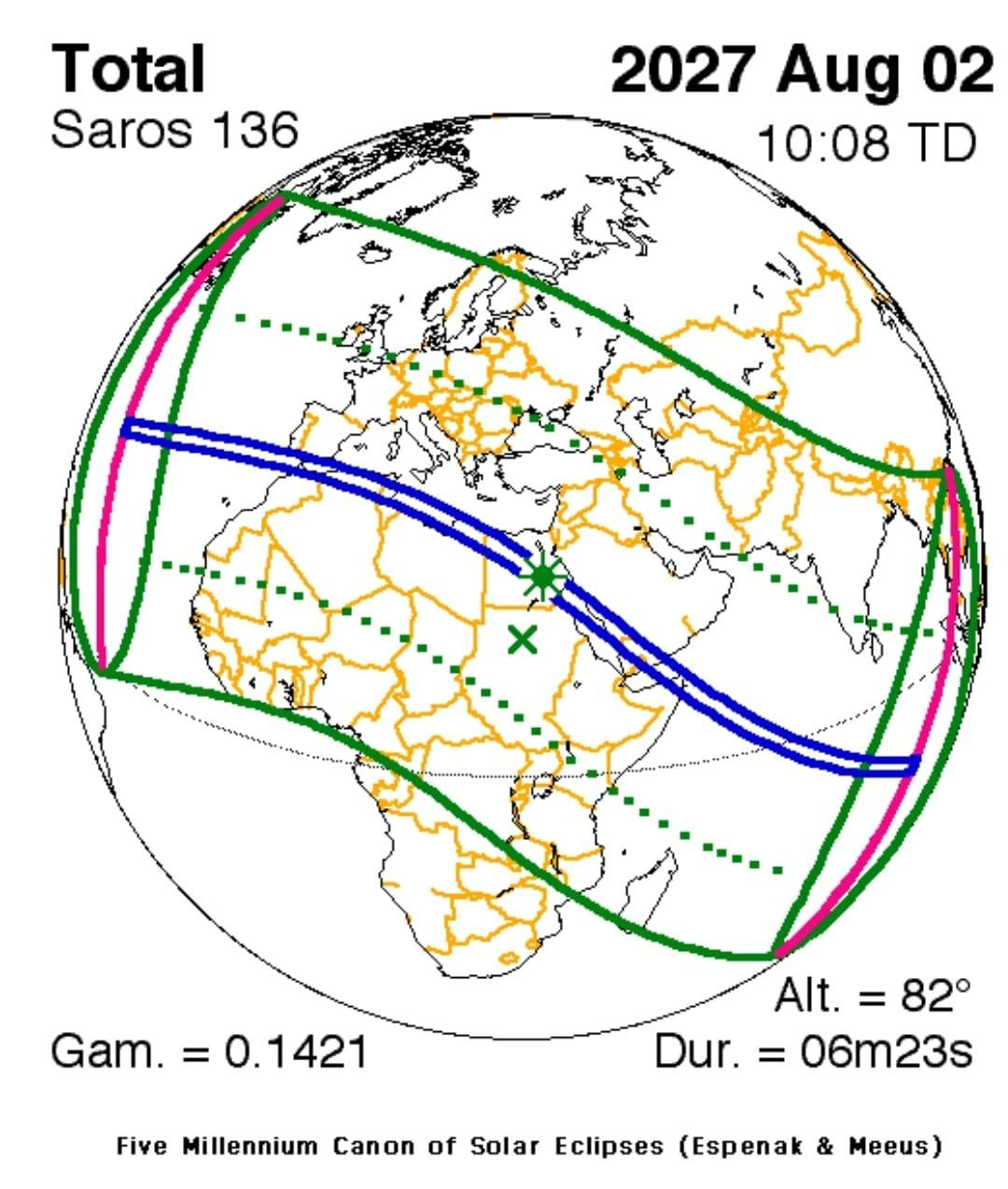
أسلوب سلس وسرد ماتع فيه من التشويق مايجعل القارئ يحبس أنفاسه في ترقب، ترقب ما قد يمكن أن يحدث للشباب الثلاثة الذين أخذوا المعول فهدموا به أولا معتقدات أهل المنطقة وماراجت فيها من حكايات وأساطير، ثم لخوض تجربة الحفر لاكتشاف ما قد تزخر به البرية من كنوز. لكن الكنز الأكبر في اعتقادي هو معرفة أن ماكنا نؤمن به لسنوات طويلة ماهو إلا محض قصص وحكايات من نسج الخيال.
«لكن الكنز الأكبر في اعتقادي هو معرفة أن ماكنا نؤمن به لسنوات طويلة ماهو إلا محض قصص وحكايات من نسج الخيال.»
خلاصة القول، تحياتي لك استاذة.